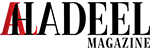جريمة بشعة هزّت مصر والعالم العربي، بطلها طفل لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره.
يوسف أيمن عبدالفتاح، فتى من مدينة الإسماعيلية، يعيش مع والده وأشقائه الصغار في غياب الأم التي تركت المنزل وتزوجت من عمّهم، تاركة أطفالها لمصيرٍ قاسٍ.
يوسف، الذي تحوّل من طفلٍ يحتاج احتواءً إلى “أمٍ وأبٍ بديلَين”، كان يقوم بكل مهام المنزل من تنظيفٍ وطبخٍ ورعايةٍ لشقيقيه، بينما والده يعمل نجّارًا من الفجر حتى الليل.
عاش الفتى عزلةً تامة، بلا أصدقاء ولا تواصل اجتماعي، وكان هاتفه المحمول رفيقه الوحيد.
لكن الصمت انفجر فجأةً حين استدرج يوسف زميله إلى منزله، ليحوّل مشهدًا شاهده في أحد أفلام الرعب إلى واقعٍ دموي.
فقد ضرب زميله بعصا خشبية حتى فارق الحياة، ثم استخدم أدوات حادة ومنشارًا كهربائيًا لتقطيع الجثة إلى أجزاء، تخلّص من معظمها قرب “كارفور الإسماعيلية”، واحتفظ بجزءٍ من ساق صديقه، قام بطهيه وتذوقه، قائلاً للمحققين إن “طعمها لذيذ جدًا”.
التحقيقات كشفت أن الطفل نفّذ الجريمة بتأثرٍ مباشر بمشاهد العنف السينمائي، وأنه أقدم على ما فعل دون وعيٍ تامٍ بخطورة فعله.
الجيران لم يشكّوا بشيء، إذ اعتادوا سماع صوت المنشار الصادر عن عمل والده في النجارة.
النيابة أمرت بإيداع يوسف في إحدى دور الرعاية لمدة سبعة أيام قابلة للتجديد، وإرسال الأدوات والدماء إلى الطب الشرعي لإجراء الفحوص اللازمة، بما في ذلك تحليل الحمض النووي والبول للتأكد من خلوه من أي مواد مخدّرة.
لكنّ الجلسة الثانية من التحقيقات حملت مفاجأة، إذ بدّل يوسف بعض أقواله، ما دفع المحققين للاشتباه بوجود طرفٍ آخر في الجريمة.
تم استدعاء الأب والتحقيق معه، وسط مؤشرات تشير إلى احتمال وجود من ساعد يوسف أو حرّضه على الفعل، خاصة مع ورود معلومات حول علاقته بمحتوى من “الدارك ويب” يشجّع على ارتكاب جرائم مماثلة.
وفي تعليقٍ تحليلي على الجريمة، قالت الأخصائية النفسية فاطمة اليوسف إن ما فعله يوسف ليس مشهدًا سينمائيًا، بل نتيجة تفكك نفسي وأسري واجتماعي ترك طفلاً يربّي نفسه في عالمٍ قاسٍ بلا حنان ولا حدود.
فقد عاش يوسف الحرمان العاطفي، وانعدام الاحتواء، وتحمل مسؤوليات تفوق عمره، ما ولّد داخله خواءً وعدوانًا مكبوتًا.
وتابعت الأخصائية:
> “يوسف لم يكن شريرًا بالفطرة، بل طفلًا يطلب المساعدة بطريقته الوحشية.
الجريمة كانت صرخة تقول: علّمني أن أكون إنسانًا قبل أن أضطر أن أكون قاتلًا.”
وأضافت أن غياب الدعم النفسي، وترك الأطفال أمام شاشات المحتوى العنيف، وتحميلهم أعباء الكبار، كلها عوامل تُنتج جيلًا فاقدًا للتعاطف ومشوَّه الهوية.
جريمة الإسماعيلية لم تكن فقط مأساة لطفلين، بل مرآة عاكسة لأزمة عميقة في التربية والمجتمع.
حين يغيب الحب، ويُستبدل الحنان بالواجب، والعائلة بالعزلة، يصبح العنف اللغة الأخيرة لطفولةٍ لم تجد من يحتضنها.