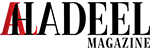الأساس في خطاب “اليسار” هو الإيحاء بـ”الحرص” على أملاك الدولة بوصفها “ثروة الأجيال اللاحقة”. من هذا المنطلق يرفض أن تتحمّل الدولة مسؤولية أزلامها من الفاسدين. فكانوا من خلال تلك الطروحات بمنزلة “حماة” السلطة من حيث لا يعلمون (على الأرجح يعلمون)،
أتمّت الأزمة الاقتصادية في لبنان سنتها الثالثة ودخلنا الرابعة، وحتى اللحظة لم يتغيّر في المشهد أيّ شيء يُذكر، سوى ارتفاع سعر صرف الدولار المتواصل، مع مواصلة السلطة السياسية لعبة شراء الوقت والمراوغة، وهذا أدّى في نهاية المطاف إلى انهيار الاقتصاد بالكامل و”نحر” القطاع المصرفي.
من ينظر إلى أنجح اقتصادات دول العالم يستطيع أن يلاحظ التناغم بين ازدهار القطاعات المصرفية ونسب النمو المرتفعة وقدرتها على خلق فرص استثمارية جديدة… إلّا في لبنان حيث السلطة كانت وما زالت تنظر إلى هذا القطاع على أنّه “بقرة حلوب” وظيفتها “درّ” الأموال لتغذية فساد السلطة. تواصلت هذه الوظيفة عقوداً ثلاثة بسبب الترغيب الذي مارسته السلطة على عدد من المصارف من خلال الفوائد المرتفعة.
أتمّت الأزمة الاقتصادية في لبنان سنتها الثالثة ودخلنا الرابعة، وحتى اللحظة لم يتغيّر في المشهد أيّ شيء يُذكر، سوى ارتفاع سعر صرف الدولار المتواصل
تعوّدت الحكومات المتعاقبة على “حلب” المصارف، عبر مصرف لبنان، الذي كان يعطيها فوائد عالية، تتقاسمها مع المودعين، لقاء ضخّ أموال المودعين إلى البنك المركزي، الذي كان يرفد بها خزينة الدولة. ومن هناك كانت تُصرف الأموال على 4 محاور أساسية: رواتب القطاع العام، وتثبيت سعر صرف الليرة لخلق قدرة شرائية “غير طبيعية” لدى المواطن اللبناني، ودعم الكهرباء، إضافة إلى سياسات “النهب” والفساد في الإنفاق المهول لدى الحكومات المتعاقبة.
أدّى هذا النهج إلى انجرار القطاع المصرفي برمّته إلى تلك “الآفة”، وبات القطاع العامّ أكبر عميل للقطاع المصرفي من خلال “الهندسات المالية”، التي هي باختصار “لعبة فوائد” أعطت المصارف مليارات الدولارات لتبقيها على قيد الحياة منذ عام 2016، قبل أن تنفجر الأزمة نهاية العام 2019.
حصل ذلك بالترغيب تارة وبالترهيب والإكراه تارة أخرى… حتى وصلنا إلى مرحلة اندماج مخيفة. بات مصير المودعين معلّقاً بمصير دين المصارف لدى مصرف لبنان، ثمّ دين الأخير لدى الدولة، وما إن ينهار طرف من الأطراف الأربعة حتى ينهار الجميع، فما بالك حين انهارت الأطراف كلّها دفعة واحدة بين 2019 و2020؟
انهيار “الدولة” والاقتصاد
في البداية انهار الاقتصاد، ثمّ وقعت منظومة السلطة خلفه بعد “ثورة 17 تشرين”، ولم يبقَ سوى القطاع الخاص، الذي يشمل المصارف والمودعين طبعاً، ليتحمّلون النتائج منفردين. منذ 2019 يتحمّل المودع “تآكل” وديعته، من “لولار” الـ3,900 إلى الـ8,000 وصولاً إلى “لولار” الـ15,000 في أوّل شباط، في حين يبلغ سعر صرف الدولار “الفريش” في السوق السوداء 3 أضعاف “اللولار” في أقلّ تقدير.
أمّا السلطة التي تسبّبت، بكلّ أركانها، بوقوع الأزمة وتتعنّت اليوم في اجتراح الحلول، فنصّبت نفسها حَكَماً مهمّته إحصاء الخسائر وتوزيعها على المصارف وضمناً على المودعين، من دون أن تجري أيّ عملية مراجعة لسياساتها المالية على مدى 30 عاماً، بل من دون أيّ محاولة منها لرسم “هويّة اقتصادية” جديدة للبلاد، معتقدةً أنّ الأسلوب السابق القائم على الاقتراض والإسراف قابل للحياة.
صحيح أنّ المصارف لا تتهرّب من مسؤوليّتها وتقرّ بالأخطاء، وتعتبر نفسها شريكاً في هذه الأزمة منذ أن استسهلت منح الدولة أموال المودعين. لكن هل من المنطق تحميلها منفردة أعباء الفجوة المالية المتمثّلة بما يزيد على 70 مليار دولار، من أموالها المحجوزة في مصرف لبنان، والتي صرفتها الحكومات المتعاقبة؟
ثمة مَن شنّ حملة إعلامية بنجاح منقطع النظير على المصارف، لتحميلها العبء وحدها. لكن هل بـ”قتل المصارف” يمكن أن نصل إلى حلول تعيد أموال المودعين، أو تنهض بالاقتصاد ليستعيد اللبنانيون قدرتهم الشرائية ولتعود قيمة رواتبهم إلى ما كانت عليه؟
السلطة التي تسبّبت بكلّ أركانها بوقوع الأزمة وتتعنّت اليوم في اجتراح الحلول، فنصّبت نفسها حَكَماً مهمّته إحصاء الخسائر وتوزيعها على المصارف وضمناً على المودعين
شيطنة المصارف
تعود إلى عوامل عدّة الأسبابُ التي أوصلت القطاع المصرفي إلى هذا المصير المأساوي. استطاعت تلك العوامل أن تحوّل هذا القطاع إلى “شيطان رجيم”. قطاع كان بشهادة الجميع ناجحاً وبمنزلة “عمود فقريّ” للاقتصاد اللبناني، انهار في أيام وأسابيع، ثم مرّت سنوات وهو يدفع الثمن اليوم، الكتف على كتف المودع.
هذه العوامل أخذت المصارف “بالجملة”، من دون أيّ عملية تمييز بين الصالح منها والطالح. سرت في البلد “لغة شيطنة” المصارف، من دون أن تسأل اللبنانيين، وخصوصاً الـ1.5 مليون مودع تقريباً، كيف يمكن أن يستعيدوا ودائعهم أو قدرتهم الشرائية حين يحطّمون واجهة مصرف أو يصفّرون مسؤولية “الدولة” و”السلطات” المتعاقبة، ويعتبرون أنّ حقّهم في هذا الفرع المصرفي أو ذاك.
هكذا شهدنا موجة هجمات متسلسلة ضد المصارف، نتيجة الحملة الإعلامية الضخمة التي زرعت في عقول اللبنانيين أنّ المصارف هي التي “سرقتهم”، من دون توضيح كيف ولماذا وما العمل وما هي الحلول المقترحة… وراح المودعون يدخلون بأسلحتهم لأخذ وديعة بعشرات آلاف الدولارات، في حين مئات الآلاف من زملائهم يتفرّجون عليهم ويفكّرون في تقليدهم، أو أنّهم مظلومون لأنّهم لا يملكون الجرأة والسلاح.
ما هي أسباب “الشيطنة”؟
إنّ العوامل التالية هي التي أدّت إلى صناعة تلك الصورة المشوّهة للواقع:
1- بحث السلطة السياسية عن “كبش فداء” تحمِّله تبعات الأزمة، لتنجو بنفسها من النتائج وتدفع عنها الاتّهام بأنّها وراء أسباب الانهيار.
2- تردُّد المصارف في إيجاد “أرضيّة حوار” جدّية مع مودعيها، أصغاراً كانوا أم كباراً، لتستطيع أن تزرع في نفوسهم شيئاً من الطمأنينة على ودائعهم، وبدلاً من ذلك دخلت في لعبة “المصرف المركزي”، والتزمت بـ”عتبة” تعاميم مصرف لبنان على غزارتها (نحو 137 تعميماً بين أساسيّ ووسيط، وبمعدّل تعميم كلّ أسبوع)، من دون أيّ محاولة منها لرأب الصدع الذي أحدثته الأيام الأولى من الأزمة، وتستمرّ في ذلك إلى اليوم.
3- الجوّ الثوري الذي ساد ضدّ الطبقة السياسية في الأسابيع الأولى من السنة الأولى من الأزمة. هذا الجوّ سرعان ما حوّل فوهة “بندقيّته” عن السلطة التي لم يستطع إقصاء أيّ مكوّن منها بعد سقوط شعار “كلّن يعني كلّن”، إلى صدر المصارف باعتبارها الطرف الأضعف أو الطرف الأكثر جذباً للاندفاع “الثوري”، فتوالى تحطيم الفروع وإقفالها، وتعطيل ماكينات الصرف الآلي، وصولاً إلى الغزوات المتنقّلة أخيراً. وقبل ذلك طبعاً حملة “مش دافعين” وغيرها، التي أثبتت مع مرور الوقت أنّها أضرّت بالمودعين وودائعهم.
“تنفيس” الغضب الشعبيّ
أظهرت تلك الأحداث كم كان ذاك الجوّ الثوري “مخترَقاً” في جزء يسير منه، وربّما تُحرّكه أطرافٌ مجهولة/معلومة، وفق أجندات سياسية مبيّتة، خصوصاً بعد تراجع تحرّكات “الثوار” الفعليّين في الشارع على وقع فيروس كورونا، وترك الساحة لـ”ثوار” و”غاضبين” من غير المودعين، استطاعوا أن يحرفوا موجة الغضب عن السلطة نحو المصارف (المسؤولة لكن بدرجة أقلّ).
كانت فروع المصارف في الشوارع أهدافاً سهلة لـ”تنفيس” الغضب الشعبي. وكلّ من توجّه إلى منزل نائب أو وزير أو زعيم، تمّ ضربه وسحله وفُقئت له عين أو كُسر له ضلع. أمّا المصارف فكانت بلا حماية، وبلا ظهر سياسي، والأهم أنّها كانت مستسلمة بالكامل.
آن الأوان للمجاهرة بتلك الحقيقة: آن الأوان للقول إنّ السلطة السياسية هي المسؤول الأوّل عن الانهيار المالي وسياسات الإنفاق والاستدانة وعدم الاستثمار، وتقع عليها المسؤولية الكبرى
“الطرح اليساريّ” ابتلع الرأي العامّ
وُلدت من رحم ثورة 17 تشرين مجموعات ذات طابع يساري معادٍ للرأسمالية والاقتصاد الحرّ وجدت في “الثورة” ملاذاً لنشر أفكار “العداء” لهذا الاقتصاد. في خلال الأزمات المالية في العالم، عادة ما تزدهر الأفكار اليسارية بالمعنى الاقتصادي. وهذا ما كان، لكنّ الرأي العام كان على الدوام يميل لاحقاً صوب الاعتدال في الطروحات مع ذوبان ثلوج الأزمة، ويبدأ تدريجياً بالتخلّي عن المواقف المتطرّفة بعدما يتلمّس صعوبة تحقيقها وضرورة العودة إلى قواعد السوق الحرّة… لكن في حالة لبنان فما زالنا في مرحلة “التطرّف”.
الأساس في خطاب “اليسار” هو الإيحاء بـ”الحرص” على أملاك الدولة بوصفها “ثروة الأجيال اللاحقة”. من هذا المنطلق يرفض أن تتحمّل الدولة مسؤولية أزلامها من الفاسدين. فكانوا من خلال تلك الطروحات بمنزلة “حماة” السلطة من حيث لا يعلمون (على الأرجح يعلمون)، متناسين أنّ أملاك الدولة التي يدافعون عنها هي في الحقيقة: مسروقة، منهوبة على يد عصابات التحاصص، ولا يستفيد منها إلّا أصحاب “السطوة” و”الاستزلام” لهذا الزعيم أو ذاك.
يتناسى هؤلاء أنّ دفاعهم الظاهري عن المودعين في وجه المصارف ليس إلاّ دفاعاً عن السلطة لأنّ المنطق يقتضي اصطفاف المودعين والمصارف في مواجهة مَن أكل أموالهم (السلطة) وليس العكس، وهذا طبعاً من دون إغفال مسؤولية المصارف، لكن ليس في هذا التوقيت وفي حمأة المعركة!
تناسى هؤلاء أنّ دعم الطبقات الفقيرة والهدر في الكهرباء والتحاصص كان على ظهر المودعين، بل على ظهر كبار المودعين الذين يصنّفونهم، بالجملة، “سارقين” و”فاسدين”، وأيضاً على ظهر “صغار” المودعين من أصحاب المهن الحرّة، والتجارات المتوسّطة، ومن العاملين في الخارج لعقود، ومن أصحاب الشركات الناجحة، ومن الذين قبضوا تعويضات نهاية الخدمة… كلّ هؤلاء يدفعون الثمن، كي لا نمدّ أيدينا إلى استثمار “أملاك الدولة”.
يغفل هؤلاء أنّ القروض الشخصية لبعض أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة وقروض السيارات والهواتف والأدوات المنزلية على مدى عقود كانت من أموال المودعين، الكبار والصغار والمتوسّطين، في المصارف.
كمّ الأفواه
سادت هذه الطروحات منذ نهاية 2019 إلى اليوم، وأمسى كلّ من يدافع عن القطاع المصرفي أو عن إشراك الدولة في الخسائر “عميلاً” و”خائناً”. استغلّت السلطة هذا الجوّ، وحبكت خطّتها، وتنصّلت من أيّ مسؤولية، فتناست أنّ مصلحة الاقتصاد اللبناني وتعافيه متوقّفين في الحقيقة على تعافي القطاع المصرفي، وذهبت بعيداً في “تطيير” وتأجيل قانون “الكابيتال كونترول” لسنوات.
أمّا اليوم فقد آن الأوان للمجاهرة بتلك الحقيقة: آن الأوان للقول إنّ السلطة السياسية هي المسؤول الأوّل عن الانهيار المالي وسياسات الإنفاق والاستدانة وعدم الاستثمار، وتقع عليها المسؤولية الكبرى. ولذا “الدولة” مجبرة على أن تكون أوّل من يتحمّل المسؤولية إلى جانب المصارف وأوّل من يشارك في البحث عن الحلول المناسبة. بل آن الأوان للقول صراحة إنّ مصلحة اللبنانيين ليست مع بقاء القطاع العام كما هو اليوم: منخور بالفساد وتأكله المحسوبية والتحاصص، ويعتاش على ظهور موظّفي القطاع الخاص وأموالهم. وما هو مطروح من أجل وضع حلّ عقلاني للأزمة يتضمّن إشراك القطاعين الخاصّ والعامّ في الحلّ.
يعرف الخبراء أنّ مصلحة اللبنانيين تتمثّل في قطاع مصرفي سليم معافى بعيد عن اقتصاد “الكاش” الذي تفوح منه روائح تبييض أموال، وتهرّب ضريبي، وتهريب واتّجار بالأسلحة والمخدّرات، وفي اقتصاد ائتماني مصرفي، خالق للاستثمارات، وواهب للقروض ومانح لبطاقات الائتمان، وفي قطاع مصرفي يزيد الاستثمارات وفرص العمل عبر اقتصاد ائتماني نظامي، لا عبر عمليات صيرفية غير شرعية، تعتاش على المضاربات وعلى سرقة الناس والتلاعب بعواطفهم.
آن الأوان أن نقول إنّ قتل القطاع المصرفي وكبار المودعين ليس حلّاً لتلك الأزمة
عماد شدياق اساس ميديا