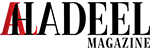يربط سلام في محاضرته بين الظروف السياسية الداخلية والخارجية والتي انعكست في الوصول لاتفاق الطائف الذي أعاد الإنتظام العام وأوقف الحرب وجدد الاعتبار لمنطق المؤسسات.
تتقدم لدى سلام مسألة ضرورة إصلاح النظام القضائي، والذي يعيش صراعات متوالية في هذه المرحلة تشير إلى انهيار هذه السلطة، وهو ما شدد عليه أمام الحاضرين وفي المناقشات التي أعقبت المحاضرة، لا سيما أن هناك حاجة ضرورية لإصلاح الجسم القضائي كملاذ أساسي لضبط الوضع العام في الدولة. كما ركز على ضرورة استعادة التوازن السياسي، وهو وحده الكفيل في فتح مسار واضح لاستعادة منطق الدولة وتطبيق ما لم يطبّق من الطائف.
وهنا نص المداخلة كاملاً:
الحقيقة انني لست من خريجي مدارس هذه الجمعية العريقة ولا من الذين درّسوا فيها، وان كنت قد مارست التعليم الجامعي لسنوات طويلة من حياتي. ولكنني اشعر اليوم وانا بينكم انني في بيتي الأوسع وبين اخوة واخوات احباء، ليس فقط لأنه مصدر اعتزاز كبير عندي ان يكون جدّي، سليم علي سلام، واثنين من اعمامي، محمد وصائب، ومن بعدهم ابن عمّي تمام، قد تسنى لهم ان يساهموا في خدمة هذه المؤسسة المرموقة من موقع رئاسة مجلس امنائها، بل أيضاً وأولاً لان المقاصد، ومنذ تأسيسها عام 1878على يد الشيخ عبد القادر القباني، ناشر جريدة “ثمرات الفنون” البيروتية، وصحبه من اهل الخير، والمقاصد عنوان للإصلاح والتقدم في المدينة، ورسالتها نهضوية تنويرية مثل رسالة الشيخيّن الكبيرين جمال الدين الافغاني ومحمد عبده، الذي اختار بيروت منفى له بعد فشل ثورة عرابي في مصر. ويُروى انه فيها كتب “رسالة التوحيد” كما كان له لقاءات وحوارات عديدة مع اهل المقاصد حول مسائل التجدد والاصلاح.
ولما كانت المقاصد تحتفل هذا العام بعيدها الـ 145، يهمني التأكيد بهذه المناسبة كم اننا في أمسّ الحاجة اليوم لأن نستلهم من تجربتها الرائدة في الانفتاح وقدرتها عل التطور في مواجهتنا لموجات الظلامية ونزعات التعصب التي تهدد عالمينا الإسلامي والعربي. وحيث انه، ومنذ مقالات الشيخ عبد القادر القباني في “ثمرات الفنون” حول شؤون الإصلاح السياسي في عصره، وقضايا حياتنا الوطنية وهموم اهل بلادنا لا تفارق القيّمين على هذا الصرح، ليس غريباً ابداً ان يكون “اتفاق الطائف” موضوع حديثنا اليوم من على “منبر المقاصد الثقافي”.
المؤشر الأخطر
لا جدال في ان الازمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان اليوم هي الأسوأ في تاريخه، لا بل ان هذه الازمة، وبحسب البنك الدولي، هي واحدة من بين ثلاث أسوء أزمات اقتصادية عرفها العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، كما ان تقاريره الأخيرة تفيد ان الانكماش الذي تشهده البلاد في الناتج المحلّي على امتداد السنوات الأربع الخيرة قد قوّض ما تحقق من نموٍّ على مدار الـ 15 سنة الأخيرة، ناهيكم ان معدل التضخم للعام المنصرم اضحى من بين الأعلى في العالم، وان مؤشر البطالة راح يناهز الـ 30%، أي تقريباً ثلاث اضعاف ما كان عليه منذ اربع أعوام، وقد بات نحو 80% من اللبنانيين يعيشون في حال من الفقر بحسب آخر الاحصاءات. ومعلوم ان العملة الوطنية قد فقدت أكثر من 98% من قيمتها منذ الأشهر الأخيرة من 2019، كما ان المودعين في المصارف بالعملات الأجنبية يتعرضون لاقتطاع قسري (Haircut) عند قيامهم بأية عملية سحب من ارصدتهم.
ومن منظار مستقبلي، لعلّ المؤشر الأخطر هنا هو ما يبيّنه التقرير الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي ومنظمة العمل الدولية من ان الرغبة في الهجرة لدى الشباب هي بنسبة 69 % ممّن هم بعمر 15 الى 24 سنة. وكذلك وجدت دراسة أعدت في معهد العلوم الاجتماعية بالجامعة اللبنانية منذ سنتين، أن 75,6 % من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، يأمل في الرحيل عن لبنان. أسباب هذه الرغبة كثيرة، أبرزها طبعاً اشتداد الازمة الاقتصادية وتقلّص فرص العمل والشعور بانسداد الأفق. ولكن الى جانب هذه العوامل، التي لا يصعب التكهن بها، دلّت هذه الدراسة الى ان 67,5 % من هؤلاء الشباب قالوا إن الأسباب وراء رغبتهم في الهجرة أسباب سياسية، ليس اقلّها انعدام الثقة.
فلا جدال هنا ايضاً ان كل ذلك انما يتطلب منّا التصدي الجاد والعاجل للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد ولمضاعفاتها الاجتماعية من خلال القيام بالإصلاحات الضرورية على الصعيد المالي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ووضع السياسات المطلوبة لبناء اقتصاد حديث وتنافسيّ، اقتصاد منتج وكفيل بتأمين النمو المستدام وتوفير فرص العمل.
المساءلة والمحاسبة
ولكن هل ممكن تحقيق ذلك دون قيام دولة قادرة وفاعلة، دولة مؤسسات وقانون توفر شروط المساءلة والمحاسبة؟ وكيف نعيد الثقة الى شبابنا وشاباتنا بالمستقبل في دولتهم، وقد بات حلمهم الغالب هو مغادرة البلاد؟
الواقع ان سلطات الدولة ومؤسساتها، تسير من سيء الى اسوأ. فمجلس النواب يعجز عن انتخاب رئيس للبلاد منذ أكثر من أربعة أشهر. وهي المرة الثالثة على التوالي التي لا يقوم بذلك ضمن المهلة الدستورية. وبالنسبة للسلطة التنفيذية، كان الفشل طوال خمسة أشهر في تشكيل حكومة جديدة إثر الانتخابات النيابية الأخيرة كما هو مُفترض، علماً انه كان قد سبق تأليف هذه الحكومة ان مرّت 9 أشهر دون ان يتمكن الرئيس المكلف حينذاك من تشكيل حكومة، فأعتذر. اما القضاء الذي بات يقف مشلولاً امام جريمة بحجم جريمة المرفأ فقد أضحى ساحة صراعات واستقطابات حادة تضاف الى ما كان يعاني منه اصلاً من أزمات، لا سيما ما هو ناجم عن محدودية استقلاله كـ “سلطة” وتدخل اهل السياسة المفضوح في عمله. وبدورها باتت الإدارات العامة، التي تعاني في الاساس من غلبة عوامل الطائفية والمحسوبية في تكوينها وإدائها، (باتت) شبه مشلولة وتقديماتها في مجالات حيوية كالكهرباء والمياه والاتصالات اما تقريبا معدومة او على تراجع كبير، ناهيكم بحال التعليم الرسمي … اما بالنسبة لما يٌشكى منه من هدرِ وانتشار واسع للفساد في الدولة فنشير الى ان موقع لبنان على مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية هو في أدني مراتب دول العالم اذ انه يحتل المرتبة 150 من 180.
ولعلّ فيما تقدم ما يكفي للبيان على ان أي من الاصلاحات او الاجراءات المالية والاقتصادية الملحة اليوم، لا يمكن ان تعطي الثمار المرجوة منها ما لم تترافق مع إصلاحات سياسية حقيقية. فهل يمكن مثلاً تصور كيفية التطبيق السليم لأي منها دون انتظام عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ وألا يصعب تصوّر القدرة على بناء مناخ الثقة المطلوب لجذب الاستثمارات، ووضع البلاد على طريق النمو، من دون قضاء مستقل؟ وكذلك ألا يصعب التصور ان مؤسسات الدولة واداراتها يمكن ان ترقى اليوم الى مستوى التحديات الجسام للنهوض بالبلاد اذا استمرت فيها الغلبة لعوامل المحسوبية والطائفية، ولو على حساب الجدارة والكفاءة.
عودة إلى الطائف
والحديث عن البعد السياسي للازمة التي نواجهها اليوم، وعن اهميّة الاصلاح السياسي المطلوب يقودنا حكماً الى السؤال عن أسباب الخلل، لا بل الاختلالات، في حياتنا الوطنية. فهل هي مثلاً تعود الى بعض احكام “اتفاق الطائف” ام انها تكمن في طريقة ممارستها، ام انها في الاثنين معاً.. لاسيّما ان اتفاق الطائف اضحى مرجع دستورنا، كما عدل عام 1990؟
ولكن لا بدّ من الاشارة هنا انّه، وإنّ كانت الإصلاحات السياسية هي حجر الزاوية في “وثيقة الوفاق الوطني” التي باتت تعرف بـ “اتفاق الطائف”، والتي تبنّاها النواب اللبنانيون الذين اجتمعوا عام 1989 في المملكة العربية السعودية، فهذا الاتفاق كان يعكس ايضاً مدى تداخل الأبعاد المحلية والخارجية في الأزمة اللبنانية الى حدٍ انه ما كان ليرى النور لو لم يشمل بنودًا متعلقة بتنظيم “العلاقة اللبنانية السورية” وأخرى بـ “تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي”، ناهيكم بالمتغيرات الإقليمية والدولية التي ساهمت بدورها بالوصول الى هذا الاتفاق، ولا سيما انحسار التوتّر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي خلال عهد غورباتشوف.
ومن ناحية أخرى، يقتضي التذكير اولاً بأهمية ما تحقق مع اتفاق الطائف عند اعتماده، إذ انه ادّى الى إسكات لغة المدافع، وإطلاق عملية سياسية قادت الى اجتماع مجلس النواب للتصديق رسمياَ على الاتفاق، فإلى انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة مركزية واحدة بعد أكثر من سنة من الشغور الرئاسي ومن وجود حكومتين متصارعتين على السلطة وعلى الشرعية الدستورية. وكذلك سمح اتفاق الطائف بإعادة توحيد الجيش المنقسم على ذاته، وحلّ الجماعات المسلحة، او الميليشيات كما كانت تسمّى، باستثناء “حزب الله” الذي كان له “معاملة خاصة” بسبب استمرار احتلال إسرائيل لأجزاء من الجنوب والبقاع الغربي. ونتيجةً لاتفاق الطائف، تم اسقاط الحواجز التي كانت قد قسّمت أرض البلاد لسنوات طوال وحالت دون حرية حركة اللبنانيين في وطنهم.
ومن باب التذكير ايضاً، يمكننا ايجاز السمات الرئيسية للصيغة السياسية الجديدة التي ارساها اتفاق الطائف، والتي تميّزت بتوازن أكبر وبتوزيعٍ أكثر عدلا للسلطة فيما بين الطوائف الكبرى، بما يلي:
أولاً: أضحى رئيس الجمهورية، بموجب اتفاق الطائف “رئيسًا للدولة”، وهو بحكم دوره هذا يتمتع بصلاحيات شبه تحكيمية واسعة، مثل امكانية طلب إعادة النظر في اي قانون وافق عليه مجلس النواب، او مراجعة المجلس الدستوري في شأنه ولو أعاد المجلس إقراره بغالبيته المطلقة، كما أنّه لا يزال يضطلع بدور حاسم في تشكيل الحكومة، ذلك أنّ اصدار مرسوم التشكيل يتطلّب “توقيع” كل من رئيس مجلس الوزراء المكلّف ورئيس الجمهورية.
ثانياً: ان السلطة التنفيذية التي كانت سابقاً، بحسب الدستور، منوطة كلياً برئيس الجمهورية، ولكن مقيّدة عمليًا بالعرف، نُقلت إلى مجلس الوزراء كهيئة جماعية، على أن يكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه تعزيزاً لمبدأ المشاركة الطوائفية فيه.
ثالثاً: مع أنّ الصلاحيات التنفيذية نُقلت من رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء كهيئة “جماعية” وليس إلى رئيسها، فان موقع رئيس الوزراء قد تعزّز بدوره لأنه اضحى على رأس المؤسسة التي أنيطت بها السلطة التنفيذية، فضلاً عن تكريس الصلاحيات التي كان يمارسها عرفًا. فأنّه بات مَن يضع جدول أعمال مجلس الوزراء وله أن يشرف على حسن تنفيذ قراراته.
رابعاً: أدخل اتفاق الطائف تعديلاً مهماً على تكوين مجلس النواب، فبعدما كانت المقاعد تتوزّع فيه بنسبة 6 إلى 5 لمصلحة المسيحيين، جعلها الاتفاق مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. أمّا موقع رئيس مجلس النواب فتعزّز هو أيضًا بشكل ملحوظ إذ صارت ولايته نفس ولاية المجلس، أي أربع سنوات بدل سنة واحدة. ولا يمكن للمجلس نزع الثقة من رئيسه إلّا مرّة واحدة وفي نهاية السنة الثانية من ولايته وبأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه. كما ان رئيس المجلس بات يترأس برلمانًا هو أيضًا أكثر استقرارًا إذ لم يعد في استطاعة السلطة التنفيذية حلّه إلّا في حالات أربع، كلّها يَصعُب أن تتحقّق شروطها.
“الصفقة الشاملة”
وعلى رغم الأهمية الدستورية لهذه الإصلاحات السياسية، فالحقيقة انه لا يمكن فهمها في إطارٍ دستوري بحت، بل يجب النظر إليها أيضًا كانعكاس لموازين القوى بين الطوائف الكبرى الثلاث، لا سيما ان المناصب العليا في الدولة هي من نصيبها.
والواقع ايضاً ان معظم هذه الاصلاحات لم يكن بالجديد حقاً، حيث ان العديد منها كان قد ورد في نصوص مشاريع تسويات سابقة، من “الوثيقة الدستورية” لعام 1976 الى ما عرف بـ”اقتراح الحسيني – الحص” لعام 1989 مروراً بـ “الاتفاق الثلاثي”. ولكن جديد اتفاق الطائف لا بل ميزته الاساسية، هو انه فضلاً عن اقراره بتشابك الأبعاد الداخلية والخارجية للازمة في لبنان، فانه وُضِع بصيغة الـ “الصفقة الشاملة” (اوالسلّة)، أي انه كلٌّ مترابط، ولاسيما فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية، لا بل ان بعض احكامه يستند ضمناً الى مبدأ المقابلة، أي “إجراء مقابل إجراء”، كما أنّ بعض بنوده كتلك الواردة في مقدّمته، والتي اُدخلت من ثم في مقدمة الدستور، انما تعكس في حدّ ذاتها المنطق نفسه من التوازي. فالبندان “أ” و”ب” من مقدمة الدستور المعدّل يقدمان مثلاً صياغة “تبادلية” (ان جاز التعبير) وجديدة لمسألة هويّة لبنان، وهي المسألة الخلافية التي قسّمت اللبنانيين طويلًا وكانت موضع نقاشات حامية منذ قيام لبنان المعاصر. والمقصود هنا انه في حين تنصّ هذه الصيغة على أنّ لبنان “وطن نهائي لجميع أبنائه” فإنّها تؤكد كذلك أنّه “عربي الهوية والانتماء”.
وما يهمّنا هنا من التشديد على طبيعة “الصفقة الشاملة” لاتفاق الطائف انه في أصل الخلل او الاختلالات التي نعاني منها ان الاتفاق طبّق بشكل منقوص وانتقائي.
فلجهة الإصلاحات السياسية، يكفي للدلالة على ذلك التذكير بعدم تطبيق “اللامركزية الإدارية الموسعة” المنصوص عنها في البند “أ” من قسم “الإصلاحات الأخرى”. ولا شك عندي ان عدم تنفيذ هذا البند هو من العوامل التي جعلت البعض يعود اليوم الى الدعوة الى اعتماد صيغ فدرالية للبنان.
وكذلك هو حال موضوع “تدعيم استقلال القضاء” المنصوص عنه في البند “ب” من القسم نفسه، الا اذا قَبِلنا تصوير البعض بان التعديل الذي ادخل بعد الطائف على تشكيل مجلس القضاء الأعلى بجعل اثنين من اعضائه العشرة منتخبين، وحصراً من بين رؤساء غرف محكمة التمييز ومن قبل أعضاء هذه المحكمة دون سواهم من قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية، انما هو التطبيق المطلوب لما نص عليه هذا الاتفاق. وهذا امر لا يمكن ان يستقيم طبعاً.
ومعلوم انه لم تر النور ايضاً “الهيئة الوطنية” التي كان من المفترض، وفق المادة 95 المعدلة من الدستور، أن يشكلها “مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين”، أي المجلس المنتخب عام 1992، من أجل “دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية” و”متابعة تنفيذ الخطة المرحلية” لذلك. وهذا بحد ذاته يشكل انتهاكاً فاضحاً ومتمادياً (لأكثر من ثلاثين عام) للطائف وللدستور.
وحيث ان طبيعة “الصفقة الشاملة” لاتفاق الطائف لا تقتصر على البنود المتعلقة بالإصلاح السياسي وحدها، لا بد من التذكير ايضاً بالخلل الناجم عن عدم تطبيق ما نصّ عليه اتفاق الطائف لجهة “إعادة تمركز القوات السورية في لبنان في سهل البقاع و”إذا دعت الضرورة في نقاط أخرى” في غضون فترة لا تزيد على سنتين من تأليف حكومة وفاق وطني وإقرار الإصلاحات الدستورية. والامر لم يقتصر هنا على عدم الالتزام بمهلة السنتين كحدٍ اقصى، بل الحقيقة ان طريقة تطبيق بعض الإصلاحات السياسية او تأجيلها صار يخضع أكثر فأكثر للنفوذ السوري المتنامي في لبنان، خصوصًا بعد التوافق الأميركي السوري الذي أعقب دعم سوريا للتحالف المناهض للعراق إثر احتلاله الكويت وموافقتها على المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام والمفاوضات الثنائية التي تلته.
التحريف في التطبيق
وان كانت الانتقائية في تطبيق احكامٍ من الطائف دون أخرى قد قوّضت طبيعة “الصفقة الشاملة” للاتفاق، فكيف والحال، أنّه فضلا عن ذلك، قد تعرّضت العديد من الإصلاحات التي يتضمنها إلى التحريف في مرحلة التطبيق أو إلى التشويه في الممارسة؟
ويجسد هنا البند الخاص في اتفاق الطائف بإقرار “قانون جديد للانتخاب بجعل المحافظات دوائر انتخابية … بعد إعادة النظر في التقسيم الاداري” نموذجًا لما لحق أحد الأحكام المهمة لاتفاق الطائف من تحريف وتشويه عند وضعه موضع التنفيذ.
كان تحقيق المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في مجلس النواب الذي انتخب عام 1992 يستوجب زيادة عدد المقاعد من 99 إلى 108 تطبيقًا لاتفاق الطائف. لكن القانون الذي أجريت الانتخابات بموجبه، رفع العدد إلى 128 مقعدًا، مما يشكل مخالفة صريحة لنص الاتفاق. وكان واضحًا أنّ القصد من هذا التحريف هو الاستجابة للرغبة السورية آنذاك بإدخال أكبر عدد من حلفائها إلى البرلمان.
والمخالفة الأخرى في هذا الصدد هي انه حيث دعا اتفاق الطائف إلى انتخابات تجرى على مستوى المحافظات، أملًا في تعزيز المصالحة الوطنية بعد سنوات من الحروب عبر تشجيع قيام تحالفات تخترق الحدود المحلية والطائفية، فإنّ اول قانون انتخاب تم اعتماده بعد اتفاق الطائف، انما تبنّى نظامًا هجيناً ونقيضاً لذلك: ففي الجنوب جرى دمج محافظتين في دائرة انتخابية واحدة. وفي محافظة جبل لبنان جرى اعتماد الأقضية دوائر انتخابية. أمّا في محافظة البقاع فكان التقسيم أقلّ انسجامًا، بحيث جرى اعتماد القضاء في دائرة انتخابية واحدة فيما تألفت الدوائر الأخرى من قضاءين. ولم تعتمد المحافظة دائرة انتخابية واحدة إلّا في بيروت والشمال.
والمثال الثاني على التحريف في التطبيق هو انه بينما كان اتفاق الطائف يمنح المجلس الدستوري صلاحية تفسير الدستور، فلقد جرى اسقاط ذلك من صلاحيات هذا المجلس في التعديلات الدستورية التي اعتمدت عام 1990 والتي كان يُفترض فيها اعطاء إصلاحات “الطائف” مفاعيلها القانونية.
فشل مجلس الوزراء
أمّا كيف خضعت بعض إصلاحات اتفاق الطائف التي “طبّقت” إلى التشويه عبر الممارسات التي تلت، فأفضل تجسيد لذلك هو مصير مجلس الوزراء. فقد كان الهدف من نقل السلطة التنفيذية إلى مجلس الوزراء كهيئة جماعية إيجاد حلّ عادل لمسألة المشاركة الطوائفية في الحكم.
ولكن فَشِل مجلس الوزراء في أن يصير حقيقةً مؤسسة دستورية لوضع السياسات أو حتى لاتخاذ القرارات. واستنادًا إلى تجربته وزيراً للدفاع ثمّ للإعلام في الحكومتين الأولى والثانية بعد اتفاق الطائف يكتب ألبير منصور في “الانقلاب على اتفاق الطائف”:
“جميع القرارات الهامة والأساسية كانت تتخذ خارج مجلس الوزراء، ثمّ تطرح فيه للتصديق عليها. ولم يكن اتخاذ القرارات خارج مجلس الوزراء يتمّ من موقع تحضيرها لإقرارها فيه، بل من موقع إقرارها خارجه وعرضها عليه للمصادقة، لم تكن تحضيرًا لقرار مجلس الوزراء بل تقريرًا عنه”.
والواقع انه في الممارسة، قد صادرت لفترة غير وجيزة وظائف مجلس الوزراء “ترويكا”، لا أساس دستوري لها، تتقاسم السلطة بين أعضائها وتتألّف مما اصطلح على تسميته بـ “الرؤساء الثلاثة”، أي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، يعملون كممثلين لطوائفهم وكشاغلين لمناصبهم الدستورية في وقت واحد. مع هذا، كان صعبًا على هذه “الترويكا” أن تحكم فعلاً، لأنّ أعضاءها كثيراً ما كانوا يختلفون حول الصلاحيات وحصص كل منهم، وعلى الأخصّ فيما يتعلّق بتعيينات الموظفين أو إنفاق الأموال العامة، مما عزّز من دور الحَكَم والحاكم في آن التي كانت تلعبه سلطات الوصاية السورية في هذا الزمن … وبعدها كان قيام ما عُرف بـ “هيئاتٍ” للحوار الوطني والتي راحت بدورها تتقاسم مع مجلس الوزراء مهمة “وضع السياسات” العامة للبلاد، ناهيكم بان تشكيل الحكومات اخذ يخضع منذ اتفاق الدوحة لعام 2008 لقواعد جديدة لا علاقة لها باحكام اتفاق الطائف مثل مسألة “الثلث المعطل\ او الضامن” و القول بـ”حصة وزارية” لرئيس الجمهورية بينما هو بحسب الدستور المعدّل “لا يشارك في التصويت” ان حضر مجلس الوزراء.
الطائفية السياسية
وما لا يقل خطورة هنا هو انه فضلاً عن عدم تطبيق البند المتعلق بتشكيل “الهيئة الوطنية” المولجة “دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية” مع انتخاب اوّل مجلس نواب على أساس المناصفة (أي عام 1992) بحسب ما نصت عليه المادة 95 من الدستور، كما أشرنا، فانه تم أيضاً في الممارسة انتهاك احكام هذه المادة في وجوه ثلاث اخرى. فبينما هي تنص على انه ” تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة … باستثناء وظائف الفئة الأولى (وما يعادلها) وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص اية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة”، فإننا نجد ان العمل بالقاعدة الطائفية لم يقتصر على المحافظة على المناصفة في وظائف الفئة الأولى وحدها بل راح، على العكس، ينسحب على كل فئات الإدارة حتى أدني الرتب فيها وصولاً الى توظيف حراس الاحراج. كما ان العديد من الوظائف العامة، وليس تلك العائدة للفئة الأولى فقط، إن في الإدارة او السلك الديبلوماسي او القضاء او الجيش والأجهزة الأمنية، أضحت أيضا مخصصة لأبناء طائفة دون غيرها، مثل تخصيص مناصب القناصل او المستشارين، ناهيكم بالسفراء، لأبناء مذاهب محددة في معظم المدن والبلدان وذلك خلافا ايضاً لنص المادة 95 ، وأخيراً فان الوجه الثلث لمخالفة هذه المادة في الممارسة فهو في سيادة عنصري الانتماء المذهبي و المحسوبية عند التعيين في الإدارة خلافاً لما اتى مرّتين في هذه المدة من ضرورة التقيد بمبدأي “الاختصاص والكفاءة”.
يتبيّن لنا مما تقدم خطورة الاختلالات الناتجة عن مدى كل من الانتقائية والتشويه التي تعرض لها تطبيق اتفاق الطائف وتأثيراتها السلبية على حياتنا الوطنية. وامام هذه الاختلالات السؤال البديهي الذي يفرض نفسه هو “ما العمل”؟
طبيعي ان تتعدد الأجوبة على هذا السؤال، ولكنني أسرع للقول انني من بين الذين يعتبرون انه طالما ان اتفاق الطائف لا يزال يشكل الأساس الذي يرتكز اليه سلمنا الأهلي، وان الدستور الذي عدّل بموجبه قد اضحى مرجعيّة الشرعية السياسية في البلاد، فيكون علينا العمل اولاً على تنفيذ أحكام الطائف التي لم تنفَّذ بعد، وعلى تصحيح ما شُوّه منها عند التطبيق، وعلى سد ثغرات الاتفاق التي ظهرت في الممارسة. ولكن يقتضي كذلك الاستفادة من الامكانيّات التي تختزنها المبادئ التي تكرست بموجب الطائف في مقدمة الدستور مثل “اعتبار إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني اساسي يقتضي العمل على تحقيقه” ومن آلية “الهيئة الوطنية”، المفترض انشائها لهذا الخصوص منذ 1992، من اجل العبور الى “الدولة المدنية” التي يتساوى فيها المواطنون حقاً ويسود فيها حكم القانون.
ونذكر اولاً الى ان بسط سلطة الدولة “على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية” بحسب ما نص عليه اتفاق الطائف امر لم يتحقق بعد، كما هو معلوم. لا بل انه من المسائل الأساسية العالقة منذ إقرار الاتفاق حيث تقتضي الإشارة أيضًا الى ان ما اعتبرناه “المعاملة المميّزة” التي حظي بها “حزب الله” في الحفاظ على سلاحه بسبب الاحتلال الإسرائيلي، راحت تتحول بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000 الى مصدر خلاف سياسي وتوترات طائفية في البلاد. والواقع ان هدف بسط سلطة الدولة على كامل اراضيها “بواسطة قواها الذاتية”، بات مرتبطاً بالاتفاق على “استراتيجية” للدفاع الوطني، والتي يُفترض ان تعالج ايضاً قضية مستقبل سلاح “حزب الله”. فالبحث في مضمون هذه الاستراتيجية وإقرارها هو المطلوب اليوم.
وفي مقدمة احكام الطائف الاخرى التي لا يزال مطلوب تنفيذها فضلاً عن تشكيل “الهيئة الوطنية”، هو بند “تعزيز استقلال القضاء”، لأنه المبدأ الأساسي للفصل بين السلطات. وفي تحقيقه حماية أكبر للحقوق والحريات مما يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين انهم، بلجوئهم الى القضاء، سوف ينالوا احكاماً عادلة مبنية على قواعد القانون ووقائع القضية وليس احكاماً منحازة ناتجة عن تأثيرات او تدخلات مرجعيات سياسية او دينية او فعاليات مالية، او غيرها. وفي ذلك ما يساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة المطلوب لجذب الاستثمارات، وإطلاق النمو، ناهيكم أن لسلطةٍ قضائيةٍ معزّز استقلالها، دوراً اكيداً ومطلوباً في مكافحة الفساد المستشري في البلاد.
دولة القانون
وبهذا الصدد، ومن اجل تعزيز مفهوم “دولة القانون” لا شك ان في إعادة صلاحية تفسير الدستور الى المجلس الدستوري، بحسب ما نصّ عليه اتفاق الطائف، ما سوف يعزِّز من شرعية مثل هذا العمل سنداً لقرينة حيادية هذا المجلس وطبيعته القضائية، بينما إبقاء صلاحية تفسير الدستور (خلافاً للطائف) لدى مجلس النواب ينطوي على خطر تعريض أي تفسير قد يُقدم عليه للانتقاد بحجة انه تفسير وضع لخدمة المصالح السياسية للأغلبية البرلمانية. ولا داعي للتشديد هنا على أهمية هكذا تصويب في ضوء ما تشهده البلاد من سجالات حول معنى هذه المادة او تلك من الدستور.
والمطلوب ايضاً تنفيذ “اللامركزية الإدارية الموسعة” كما نصّ عليها اتفاق الطائف. ولا شك ان القيام بذلك سوف يؤدي الى تحفيز التنمية وتعزيز الرقابة المحلية، كما انه يساهم إلى حد ما بالحفاظ على بعض الخصوصيات المناطقية. غير أنه من اجل تحقيق ذلك، لا بد من رفض التفسيرات القصوى التي يحاول البعض من هنا وهنالك اعطاءها للامركزية المطلوبة؛ أي تلك التي تسعى الى الحد من نطاقها بحيث لا تتعدى اللاحصرية الادارية من ناحية، وتلك التي ترغب في توسيع نطاقها إلى شكل من أشكال الفيديرالية من ناحية أخرى.
اما بالنسبة للإدارة، فالمطلوب هو الاقلاع عن الممارسات المخالفة للمادة 95 من الدستور نصاً وروحاً. والمقصود ببساطة ان لا تعود وظائف معيّنة مخصصة لطوائف محددة، وان يتم تغليب معايير الجدارة والكفاءة بالنسبة إلى جميع الوظائف في وعلى كلّ المستويات، مع احترام مبدأ المناصفة في الفئة الاولى وحدها. وهذا لن يغلب مبدأ المساواة بين المواطنين على غيره من المعايير فحسب، بل يساهم أيضا في تحسين فعالية الإدارة ونوعية خدماتها، فضلا عن وضع حدٍ للزبائنية والمحسوبية اللتين تشكلان الركيزتين الرئيسيتين للفساد والهدر فيها.
ولكن قد يسأل البعض: هل ذلك ممكن والطائفية آخذة تترسخ منذ اندلاع الحرب في لبنان عام 1975؟ والحقيقة أنه كلما ترسخت الطائفية، كلما زادت آثارها الضارة. لذلك، فإن ازدياد قوة هذه الظاهرة يجب أن يقودنا إلى إدراكٍ أكبر للحاجة إلى إعادة النظر في الدور المركزي الذي تستمر في لعبه في حياتنا العامة، بدل الاستسلام لها وكأنها قَدَرٌ محتوم. وبطبيعة الحال، فقد أضحت هذه المهمة أكثر تعقيدًا مما كانت عليه قبل عام 1975، او عند إقرار الطائف. ولكنها أصبحت أيضًا أكثر إلحاحًا بسبب الانتشار المستمر لضرر الطائفية، في مختلف إدارات الدولة وعلى كافة مستوياتها.
وابعد من الإدارة، يقتضي التذكير هنا ان المادة 22 من الدستور المعدلة عام 1990 قد رسمت بداية الطريق الى تجاوز الطائفية اذ قالت باستحداث “مجلس للشیوخ تتمثل فیه جمیع العائلات الروحیّة وتنحصر صلاحیاته في القضایا المصیریة مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي”. ولعلّ الوقت قد حان للتفكير الجاد بالآليات التي تسمح بوضع هذه المادة موضع التطبيق.
إصلاحات وثغرات
وفي الختام، قد لا يكفي إعادة الطائف الى مساره الأصلي، بل لا بد ايضاً من سد ما ظهر فيه من ثغرات خلال الممارسة. واكتفي هنا بالشارة الى اهم ثلاث منها:
اولا: لا يحدد الدستور أي إطار زمني لبدء الاستشارات او لتكليف رئيس حكومة جديد في حال حدوث ما يستلزم ذلك، مثل استقالة رئيس الحكومة او اية “حالات” أخرى “تُعتبر الحكومة مستقيلة” بموجبها. والدستور لا يفرض كذلك مهلة على الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة. لسد هذه الثغرة، لا شك انه لا بد من تحديد مهل واضحة لذلك كما يطالب البعض. ولكن هل يكفي ذلك لتجاوز العقبات التي قد تحول دون تشكيل الحكومة في حال استمرار الخلاف بين رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية؟ والجواب هو طبعاً “لا”. ويبدو ان انسب علاج لحالات كهذه يكون بوضع آلية تسمح باللجوء الى تحكيم مجلس النواب لكونه “مصدر السلطات”. والصيغ عديدة لذلك.
ثانياً: هناك مشكلة اضافية، لا حل لها في الطائف، تتعلق بحسن سير عمل السلطة التنفيذية في حال عدم توقيع الوزير المعني على مرسوم يضع حيّز التنفيذ قرارا اتُخِذ في مجلس الوزراء، او حتى تأجيل التوقيع عليه من دون مبرر مقبول. فمن اجل تفادي مأزق دستوري كهذا، يجب اعتبار قرار مجلس الوزراء نافذا بعد أسبوع (او عشرة أيام) من اتخاذه حتى إذا استمر الوزير المعني على موقفه وذلك قياسا على انه لو رفض رئيس الجمهورية التوقيع على المرسوم الذي يعطي القرار المتخذ في مجلس الوزراء صيغته التنفيذية فأن الدستور ينص على ان هذا القرار يصبح نافذاً بعد خمسة عشر يومًا في حال أصر مجلس الوزراء عليه. وفي الحالة المتعلقة بالوزير يصدر عندها المرسوم ذو الصلة بتوقيع رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية فيما يعتبر الوزير المذكور بحكم المستقيل. ويستند هذا الحل الى مبدأ ان السلطة التنفيذية في ظل الطائف أصبحت مناطة بمجلس الوزراء كمؤسسة. كذلك، ففي حال اعتبر كلٌّ من رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية ان الوزير المعني قد تخلّف عن المبادرة الى اتخاذ الخطوات المطلوبة لإصدار “مرسوم عادي” في الحالات التي قد تتطلب ذلك، اقتضى منحهما إمكان عرض الامر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً في شأنه.
ثالثاً: بينما كانت كفة ميزان الصلاحيات بين السلطتين التنفيذية والاشتراعية تميل في مرحلة ما قبل اتفاق الطائف إلى السلطة التنفيذية، انقلبت مع اتفاق الطائف إلى السلطة الاشتراعية بدل أن يقيم توازنًا بينهما. والتوازن المقصود هنا هو من المبادئ الدستورية الأساسية في الأنظمة البرلمانية حيث أنّ مسؤولية الحكومة تجاه البرلمان وقدرة الأخير على إسقاطها بحجب الثقة عنها إنّما تقابله قدرة الحكومة على حلّ البرلمان. ويُعرف هذا المبدأ في الفقه الفرنسي بمعادلة moyens d’action réciproques entre gouvernement et parlement. والواقع انه بموجب الطائف باتت إمكانية حل السلطة التنفيذية لمجلس النواب تقتصر على أربع حالات من المستبعد جدا حدوثها وهي امتناع مجلس النواب عن الاجتماع طوال عقد او طوال عقدين استثنائيين متواليين لا تقل مدة كل منهما عن الشهر او في حال ردِّه الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل والحالة الرابعة هي أصرار المجلس بأكثرية ثلاثة ارباع أعضائه على مشروع تعديل للدستور لم توافق عليه الحكومة. وإعادة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يكون بنظرنا بإزالة لائحة الشروط هذه المطلوب توفّرها لإمكان حل مجلس النواب واستبدالها بتشديد القيود الخاصة بظروف الحل وتوقيته، كمنع اللجوء مثلاً الى هذا الخيار خلال السنة الأولى من ولاية المجلس كما تنص عليه المادة 12 من الدستور الفرنسي، على سبيل المثل.
وفي الختام، اعود للتأكيد ان الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة اليوم يصعب ان تعطي ثمارها المرجوة ما لم تترافق مع اصلاحات سياسية طال انتظارها. والمطلوب هنا ان يتم وضع موضع التنفيذ ما لم يطبق بعد من بنود اتفاق الطائف، وتصحيح ما نفذ منه ان خلافاً لنصه او لروحه، والعمل على سد ثغراته التي بيّنتها ممارسة السنوات الماضية. والمقصود هنا ليس إعادة توزيع للسلطة بين الطوائف المختلفة بل المقصود هو تعزيز دور المؤسسات الدستورية، وإعلاء مبدأ “منطق المؤسسات” على اي اعتبار آخر. ولعلّنا من خلال إعادة اتفاق الطائف إلى مساره الصحيح، نعود ونضع لبنان على طريق بناء الدولة الحديثة، الدولة القادرة على فرض استقلاليّتها عن الطوائف المختلفة وتكوين حيّز خاص بها. وليس المقصود هنا دولة تُقام في وجه الطوائف من جهة، ولا دولة تقوم على تسامح الطوائف تجاهها من جهة اخرى، بل دولة قادرة على احتواء الطوائف من ضمنها وعلى تجاوزها في آن